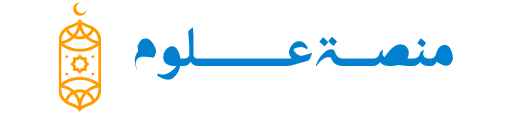سورة القلم (٦٨)
﷽
﴿نۤۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا یَسۡطُرُونَ ١ مَاۤ أَنتَ بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ بِمَجۡنُونࣲ ٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجۡرًا غَیۡرَ مَمۡنُونࣲ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمࣲ ٤ فَسَتُبۡصِرُ وَیُبۡصِرُونَ ٥ بِأَییِّكُمُ ٱلۡمَفۡتُونُ ٦ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِینَ ٧ فَلَا تُطِعِ ٱلۡمُكَذِّبِینَ ٨ وَدُّوا۟ لَوۡ تُدۡهِنُ فَیُدۡهِنُونَ ٩ وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافࣲ مَّهِینٍ ١٠ هَمَّازࣲ مَّشَّاۤءِۭ بِنَمِیمࣲ ١١ مَّنَّاعࣲ لِّلۡخَیۡرِ مُعۡتَدٍ أَثِیمٍ ١٢ عُتُلِّۭ بَعۡدَ ذَ ٰلِكَ زَنِیمٍ ١٣ أَن كَانَ ذَا مَالࣲ وَبَنِینَ ١٤ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَیۡهِ ءَایَـٰتُنَا قَالَ أَسَـٰطِیرُ ٱلۡأَوَّلِینَ ١٥ سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلۡخُرۡطُومِ ١٦﴾
١- يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام، التي تكتب بها [أنواع] العلوم، ويسطر بها المنثور والمنظوم.
٢- وذلك أن القلم وما يسطرون به من أنواع الكلام، من آيات الله العظيمة، التي تستحق أن يقسم الله بها، على براءة نبيه محمد ﷺ، مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى عنه الجنون بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل، والرأي الجزل، والكلام الفصل، الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام، وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا، ثم ذكر سعادته في الآخرة، فقال: ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا﴾.
٣- أي: لأجرا عظيمًا، كما يفيده التنكير، ﴿غير ممنون﴾ أي: [غير] مقطوع، بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه النبي ﷺ من الأعمال الصالحة، والأخلاق الكاملة.
٤- ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ أي: عاليًا به، مستعليًا بخلقك الذي من الله عليك به، وحاصل خلقه العظيم، ما فسرته به أم المؤمنين، [عائشة -رضي الله عنها-] لمن سألها عنه، فقالت: “كان خلقه القرآن”، وذلك نحو قوله تعالى له: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم﴾ [الآية]، ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيُصُ عَلَيْكُم بِالمْؤُمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه ﷺ بمكارم الأخلاق، [والآيات] الحاثات على الخلق العظيم فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها، في الذروة العليا، فكان ﷺ سهلًا لينا، قريبًا من الناس، مجيبًا لدعوة من دعاه، قاضيًا لحاجة من استقضاه، جابرًا لقلب من سأله، لا يحرمه، ولا يرده خائبًا، وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه، وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه، ولا يغلظ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بشره، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلي عشيره غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال ﷺ.
٥- فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون قال: ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ وقد تبين أنه أهدى الناس، وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس، [وشر الناس] للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله، وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي.
٧- و ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ وهذا فيه تهديد للضالين، ووعد للمهتدين، وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية، دون غيره.
٨- يقول الله تعالى، لنبيه ﷺ: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾ الذين كذبوك وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلًا لأن يطاعوا، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل، فالمطيع لهم مقدم على ما يضره، وهذا عام في كل مكذب، وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من النبي ﷺ، أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم، ويسكتوا عنه.
٩- ﴿وَدُّوا﴾ أي: المشركون ﴿لَوْ تُدْهِنُ﴾ أي: توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو الفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه، ﴿فَيُدْهِنُونَ﴾ ولكن اصدع بأمر الله، وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره، بنقض ما يضاده، وعيب ما يناقضه.
١٠- ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ﴾ أي: كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابًا إلا وهو ﴿مُهِينٌ﴾ أي: خسيس النفس، ناقص الهمة، ليس له همة في الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة.
١١- ﴿هَمَّازٍ﴾ أي: كثير العيب [للناس] والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء، وغير ذلك.
﴿مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ أي: يمشي بين الناس بالنميمة، وهي: نقل كلام بعض الناس لبعض، لقصد الإفساد بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء.
١٢- ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ﴾ الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك، ﴿مُعْتَدٍ﴾ على الخلق في ظلمهم، في الدماء والأموال والأعراض ﴿أَثِيمٍ﴾ أي: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى
١٣- ﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي: غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق ﴿زَنِيمٍ﴾ أي: دعي، ليس له أصل و [لا] مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق، ولا يرجى منه فلاح، له زنمة أي: علامة في الشر، يعرف بها.
وحاصل هذا، أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب، خسيس النفس، سيئ الأخلاق، خصوصًا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس، والتكبر على الحق وعلى الخلق، والاحتقار للناس، كالغيبة والنميمة، والطعن فيهم، وكثرة المعاصي.
١٤- وهذه الآيات – وإن كانت نزلت في بعض المشركين، كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه: ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: لأجل كثرة ماله وولده، طغى واستكبر عن الحق، ودفعه حين جاءه، وجعله من جملة أساطير الأولين، التي يمكن صدقها وكذبها- فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص، لتتضح به القاعدة العامة، ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة.
١٦- ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله، بأن الله سيسمه على خرطومه في العذاب، وليعذبه عذابًا ظاهرًا، يكون عليه سمة وعلامة، في أشق الأشياء عليه، وهو وجهه.
﴿إِنَّا بَلَوۡنَـٰهُمۡ كَمَا بَلَوۡنَاۤ أَصۡحَـٰبَ ٱلۡجَنَّةِ إِذۡ أَقۡسَمُوا۟ لَیَصۡرِمُنَّهَا مُصۡبِحِینَ ١٧ وَلَا یَسۡتَثۡنُونَ ١٨ فَطَافَ عَلَیۡهَا طَاۤىِٕفࣱ مِّن رَّبِّكَ وَهُمۡ نَاۤىِٕمُونَ ١٩ فَأَصۡبَحَتۡ كَٱلصَّرِیمِ ٢٠ فَتَنَادَوۡا۟ مُصۡبِحِینَ ٢١ أَنِ ٱغۡدُوا۟ عَلَىٰ حَرۡثِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَـٰرِمِینَ ٢٢ فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمۡ یَتَخَـٰفَتُونَ ٢٣ أَن لَّا یَدۡخُلَنَّهَا ٱلۡیَوۡمَ عَلَیۡكُم مِّسۡكِینࣱ ٢٤ وَغَدَوۡا۟ عَلَىٰ حَرۡدࣲ قَـٰدِرِینَ ٢٥ فَلَمَّا رَأَوۡهَا قَالُوۤا۟ إِنَّا لَضَاۤلُّونَ ٢٦ بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُومُونَ ٢٧ قَالَ أَوۡسَطُهُمۡ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ لَوۡلَا تُسَبِّحُونَ ٢٨ قَالُوا۟ سُبۡحَـٰنَ رَبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِینَ ٢٩ فَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ یَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠ قَالُوا۟ یَـٰوَیۡلَنَاۤ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِینَ ٣١ عَسَىٰ رَبُّنَاۤ أَن یُبۡدِلَنَا خَیۡرࣰا مِّنۡهَاۤ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا رَ ٰغِبُونَ ٣٢ كَذَ ٰلِكَ ٱلۡعَذَابُۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُوا۟ یَعۡلَمُونَ ٣٣ إِنَّ لِلۡمُتَّقِینَ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِیمِ ٣٤ أَفَنَجۡعَلُ ٱلۡمُسۡلِمِینَ كَٱلۡمُجۡرِمِینَ ٣٥ مَا لَكُمۡ كَیۡفَ تَحۡكُمُونَ ٣٦ أَمۡ لَكُمۡ كِتَـٰبࣱ فِیهِ تَدۡرُسُونَ ٣٧ إِنَّ لَكُمۡ فِیهِ لَمَا تَخَیَّرُونَ ٣٨ أَمۡ لَكُمۡ أَیۡمَـٰنٌ عَلَیۡنَا بَـٰلِغَةٌ إِلَىٰ یَوۡمِ ٱلۡقِیَـٰمَةِ إِنَّ لَكُمۡ لَمَا تَحۡكُمُونَ ٣٩ سَلۡهُمۡ أَیُّهُم بِذَ ٰلِكَ زَعِیمٌ ٤٠ أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَاۤءُ فَلۡیَأۡتُوا۟ بِشُرَكَاۤىِٕهِمۡ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِینَ ٤١ یَوۡمَ یُكۡشَفُ عَن سَاقࣲ وَیُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا یَسۡتَطِیعُونَ ٤٢﴾
١٧- يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم، وأمددناهم بما شئنا من مال وولد، وطول عمر، ونحو ذلك، مما يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجًا لهم من حيث لا يشعرون فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة، الذين هم فيها شركاء، حين زهت ثمارها أينعت أشجارها، وآن وقت صرامها، وجزموا أنها في أيديهم، وطوع أمرهم، [وأنه] ليس ثم مانع يمنعهم منها، ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء، أنهم سيصرمونها أي: يجذونها مصبحين، ولم يدروا أن الله بالمرصاد، وأن العذاب سيخلفهم عليها، ويبادرهم إليها.
١٨- أقسموا وحلفوا من غير استثناء، أنهم سيصرمونها أي: يجذونها مصبحين، ولم يدروا أن الله بالمرصاد، وأن العذاب سيخلفهم عليها، ويبادرهم إليها.
١٩- ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: عذاب نزل عليها ليلًا ﴿وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ فأبادها وأتلفها
٢٠- ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ أي: كالليل المظلم، ذهبت الأشجار والثمار، هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم.
٢١- ولهذا تنادوا فيما بينهم، لما أصبحوا يقول بعضهم لبعض: ﴿أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ﴾
٢٣- [فَانْطَلَقُوا } قاصدين له ﴿وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ﴾ فيما بينهم، ولكن بمنع حق الله،
٢٤- ﴿لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ﴾ أي: بكروا قبل انتشار الناس، وتواصوا مع ذلك، بمنع الفقراء والمساكين، ومن شدة حرصهم وبخلهم، أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة، خوفًا أن يسمعهم أحد، فيخبر الفقراء.
٢٥- ﴿وَغَدَوْا﴾ في هذه الحالة الشنيعة، والقسوة، وعدم الرحمة ﴿عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ﴾ أي: على إمساك ومنع لحق الله، جازمين بقدرتهم عليها.
٢٦- ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا﴾ على الوصف الذي ذكر الله كالصريم ﴿قَالُوا﴾ من الحيرة والانزعاج.
﴿إِنَّا لَضَالُّونَ﴾ [أي: تائهون] عنها، لعلها غيرها
٢٧- فلما تحققوها، ورجعت إليهم عقولهم قالوا: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ منها، فعرفوا حينئذ أنه عقوبة.
٢٨- فـ ﴿قَالَ أَوْسَطُهُم﴾ أي: أعدلهم، وأحسنهم طريقة ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ أي: تنزهون الله عما لا يليق به، ومن ذلك، ظنكم أن قدرتكم مستقلة، فلولا استثنيتم، فقلتم: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئتة الله، لما جرى عليكم ما جرى.
٢٩- فقالوا ﴿سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أي: استدركوا بعد ذلك، ولكن بعد ما وقع العذاب على جنتهم، الذي لا يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا، وإقرارهم على أنفسهم بالظلم، ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة، ولهذا ندموا ندامة عظيمة.
٣٠- ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ﴾ فيما أجروه وفعلوه،
٣١- ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ﴾ أي: متجاوزين للحد في حق الله، وحق عباده.
٣٢- ﴿عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرًا منها، ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله، ويلحون عليه في الدنيا، فإن كانوا كما قالوا، فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرًا منها لأن من دعا الله صادقًا، ورغب إليه ورجاه، أعطاه سؤله.
٣٣- قال تعالى مبينا ما وقع: ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾ [أي:] الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلب الله العبد الشيء الذي طغى به وبغى، وآثر الحياة الدنيا، وأن يزيله عنه، أحوج ما يكون إليه.
﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ من عذاب الدنيا ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ فإن من علم ذلك، أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العذاب ويحل العقاب
٣٤- يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي، من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين،
٣٥- وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهم، المنقادين لأوامره، المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه، والكفر بآياته، ومعاندة رسله، ومحاربة أوليائه،
٣٦- وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب، فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكم باطل، ورأيه فاسد،
٣٧- وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك، فليس لهم مستند، لا كتاب فيه يدرسون [ويتلون] أنهم من أهل الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا.
٣٩- وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين، ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف، فليس لهم كتاب، ولا لهم عهد عند الله في النجاة، ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة.
٤٠- ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ أي: أيهم الكفيل بهذه الدعوى الفاسدة، فإنه لا يمكن التصدر بها، ولا الزعامة فيها.
٤١-
٤٢- أي: إذا كان يوم القيامة، وانكشف فيه من القلاقل [والزلازل] والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله، طوعًا واختيارًا، ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياصي البقر